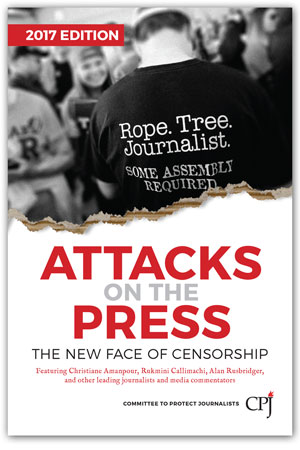صحفية ممنوعة من دخول سوريا، ويتعين عليها أن تُدرك معنى كل ما يقال لها
بقلم أليساندريا ماسي
في اليوم الذي جرى فيه الهجوم، كنت ونائب مدير التحرير مقرفصين على الكنبة الخضراء في مكتبنا الصغير في بيروت والذي يشبه الخزانة في حجمه، وكنّا نمد جذعينا خارج النافذة لننفث دخان السجائر التي أشعلناها، ونتبادل أطراف الحديث بشأن ما نعتقد أنه حدث فعلاً في سوريا في ذلك اليوم.
وهذه هي الوقائع: في 17 سبتمبر/ أيلول 2016، شنت قوات الولايات المتحدة وعدة دول شريكة في التحالف الدولي عدة غارات جوية استهدفت قاعدة عسكرية سورية في محافظة دير الزور في شرق سوريا، مما أدى إلى مقتل 62 جندياً سورياً. وكانت سوريا في ذلك الوقت في اليوم السادس من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه في الأسبوع السابق في أعقاب مفاوضات بين مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا، إلا أن الوضع كان سيئاً. وشهدت سوريا في الأيام التالية بعض أعنف المعارك منذ اندلاع النزاع في عام 2011.
وكان موقعنا الإلكتروني، ‘سيريا ديبلي’ [سوريا بعمق]، قد نشر تقريراً حول هذا الهجوم – ومعظمه عبارة عن حقائق أساسية إضافة إلى التصريحات الرسمية التي صدرت عن الأطراف المختلفة. وتضمنت تغطيتنا البيان الرسمي الصادر عن الولايات المتحدة والذي أكد على وقوع الغارات الجوية، وزعَمَ أنها كانت خطأ غير مقصود. كما أوردنا أن الأمم المتحدة عقدت جلسة طارئة فوراً سعياً لإنقاذ الهدنة الهشة. حتى أننا أوردنا أن السلطات الروسية أعربت عن غضبها وقالت إن الاعتداء يمثل برهاناً على أن الولايات المتحدة تنسق مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (ويبدو أن مقاتلي التنظيم تمكنوا من التقدم في المنطقة بعد دقائق من انتهاء الغارة الجوية). وكانت هذه بيانات موجهة إلى الصحافة كي تستخدمها لنقل المعلومات إلى الجمهور. ولكن كان من الصعب أن تجد أي شخص، بما فيه أنا ونائب مدير التحرير، يصدق أن أي من هذه التصريحات يتضمن معلومات صحيحة.
بالنسبة لي، بدا الأمر وكأنه إهانة لذكاء القراء أن نورد في تغطيتنا بأن القوات الأمريكية لم تتمكن من تمييز قاعدة عسكرية. كما أنني أتوخى الحذر في تصديق أي شيء يقوله الرئيس بشار الأسد، ولكن كان علي أن أسلم بأنه لم يكن مخطئاً تماماً عندما أشار إلى أنه “من غير المعقول أن ترتكب الخطأ نفسه لمدة تزيد عن ساعة”. وفي الوقت نفسه، فإنني تابعت الاستراتيجية الأمريكية لفترة تكفي لأن أدرك بأن التنسيق المباشر بين السلطات الأمريكية وتنظيم الدولة الإسلامية يمثل خطراً غير ضروري، لا سيما مع وجود وفرة من الوسطاء المستعدين للقيام بهذا الدور، وكان يبدو من غير المعقول أن الولايات المتحدة تعمل على تحطيم اتفاق وقف إطلاق النار الذي سعت هي نفسها إلى التوصل إليه.

وبعد بضعة أيام من ذلك، وخلال وجبة من الطعام الأرمني والنبيذ على شرفة منزلي في بيروت، أطلعني صحفي آخر على ما أدلى به متحدث باسم منظمة غير حكومية معروفة إذ وجه اللوم بشأن الهجوم إلى السلطات الروسية قائلاً إن موسكو أعطت موافقتها على هدف الهجوم قبل وقوعه.
إلا أننا لم نورد أي من هذه الاحتمالات في تغطيتنا الصحفية. وليس ذلك لأننا تقاعسنا عن إثبات نظرياتنا، أو لأننا نفتقر للموارد أو بسبب نقص فهمنا للوضع في سوريا. بل لأنه بعد ست سنوات من هذا النزاع الذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف وتدفُق حوالي 4.8 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة، والذي تورطت فيه قوى أجنبية من جميع أنحاء العالم، بات على الصحفيين الذين يغطون النزاع في سوريا أن يمارسوا الرقابة الذاتية من خلال الامتناع عن تغطية بعض الأمور. وهذا الوضع ليس جديداً – فقد ظلت تغطية سوريا تتضمن دائماً قدراً معيناً من الرقابة الذاتية، إما لأسباب أمنية (إذ يتم دائماً تغيير أسماء الأشخاص المعنيين) أو لأسباب أخلاقية (فنحن نحذف صور القتلى). ولكن الآن، وللمفارقة، صرنا نمارس الرقابة الذاتية كي نحافظ على عدم انحيازنا. فنحن نتصرف بحذر شديد من أجل المحافظة على توازن التغطية، وبما أنه لا يمكن لمعظمنا الذهاب إلى سوريا كي نرى الأحداث بأنفسنا، فأننا نضطر للاعتماد على ما يقال لنا في تغطيتنا الصحفية.
وبوصفي صحفية ومديرة تحرير لموقع ‘سيريا ديبلي’، أدركت أن الامتناع عن إيراد نظرياتنا في تغطيتنا الصحفية والاكتفاء بنشر التصريحات المشكوك بصحتها يحقق أمرين اثنين: إبلاغ القراء بحدوث الغارة الجوية، وعدم ترك أي مجال لاتهامنا بالتحيّز بوصفنا وسيلة إعلامية. فقد أوردنا بيانات جميع الأطراف.
ثمة كابوس يعاودني دائماً حول سوريا. إذ أجد نفسي استيقط في يوم ما، بعد انتهاء الحرب، وأجد أن جميع المعلومات التي أوردناها بوصفها حقائق – جميع المعلومات التي اعتقدنا أنها حقيقية – لم تكن صحيحة في واقع الأمر. وهذه الفكرة، من دون شك، غير واقعية. وفي الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور، بلغت الخسائر في الأرواح من جراء هذه الحرب 400,000 قتيل، كما تشتت العائلات، وتدمرت المدن، وفر عدد كبير جداً من الناس (ولقي الكثير منهم حتفهم أثناء الفرار)، مما شكل عبئاً كبيراً جداً على الدول الأخرى، وهناك ملايين السوريين لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم المقبلة. هذه الحقائق لا يمكن إنكارها، فالحرب تتسبب بأضرار هائلة. إلا أنني لم أشاهد هذه الأضرار بنفسي، ولا يوجد سوى عدد قليل من الأشخاص ممن أثق بهم كي يكونوا عيوناً لي في الميدان، إذ أنه بعد ست سنوات من القتال، بات عدد الأشخاص غير المناصرين لطرف من الأطراف يشكل نسبة ضئيلة من سكان سوريا. وغالباً ما تكون البيانات الحكومية مضللة على نحو صارخ، كما أن الخشية من انتقام الحكومة أو الجهات الفاعلة من غير الدول تدفع المدنيين والناشطين إلى تحوير الحقيقة وأحياناً طمسها تماماً. وبالنسبة لنا كصحفيين نغطي النزاع من خارج البلد، من الصعب معرفة ما يحدث بالفعل، لذا فإننا نمارس الرقابة الذاتية أو أننا نوفر تدريجياً منبراً لأشخاص يقدمون سرديات قد تكون بعيدة عن الواقع أو كاذبة تماماً.
عندما بدأتْ روسيا حملة القصف الجوي في سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، كنتُ مقيمة في بيروت. ومع وصول أول التقارير حول الغارات الجوية، اتصلت بأحد مصادري السوريين في بلدة تعرضت للقصف، وزودني بتسجيلات لاتصالات لاسلكية باللغة الروسية تم اعتراضها بينما كانت آتية من الطائرات. وكانت السلطات الروسية قد أصدرت بياناً زعمت فيه أنها انضمت إلى الحرب في سوريا بذريعة مقاتلة تنظيم الدولة الإسلامية. ولكن عندما نظرت إلى خريطة سوريا التي بحوزتي، وجدت أنني وضعت سابقاً دائرة حمراء حول اسم البلدة الأولى التي تعرضت للقصف – إذ أنها تخضع لحصار منذ أكثر من سنة – وكانت هذه البلدة تحت سيطرة الثوار السوريين وليس تنظيم الدولة الإسلامية.
أعرب المحررون المسؤولون عني في نيويورك عن تشككهم، وتساءلوا “ما الذي يدفع الروس لقصف الثوار عندما قالوا بوضوح إنهم يقصفون تنظيم الدولة الإسلامية؟ هذا أمر غير معقول”. وكانت معظم وسائل الإعلام قد نشرت بيان الحكومة الروسية حول استهدافها لتنظيم الدولة الإسلامية، وأنا كنتُ أزود صحيفتي بمعلومات تناقض ذلك. كان الأفراد الذين يزودوني بالمعلومات ينتمون للمعارضة، وكان عليَ أن أتوخى الحذر بسبب انتمائهم هذا؛ فثمة أسباب كثيرة تدفعهم للكذب.
وفي الأيام التالية، أصبح من المعروف أن روسيا موجودة في سوريا للدفاع عن الأسد، وبصرف النظر عن البيانات الرسمية التي تصدرها، وهذا يعني استهداف أي جماعة تعارض الأسد، بما في ذلك الثوار. ومع ذلك واصلنا تضمين البيانات الروسية في تغطيتنا الصحفية.
لقد اعتاد السياسيون على الكذب، وكان على الصحفيين دائماً أن يتحرّوا تصريحات السياسيين ويقارنوها مع الأدلة المتوفرة لبيان صحتها أو كذبها. ولكن في سوريا نجد أنه حتى الأدلة تُقدَم على نحو يتأثر بالدوافع الذاتية، كما أن سعي الصحفي للحصول على رويات شهود العيان قد تعني تعرضه للسجن أو الموت.
لذا فإننا نتوخى جانب السلامة، مما يجعل تغطيتنا تبدو كما يلي:
قصف جوي روسي يصيب مستشفى في حلب، إلا أن السلطات الروسية تزعم بأنها تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.
غارات جوية تصيب مدرسة في سوريا. ومن غير الواضح مَن نفذ الغارة – فسوريا وروسيا والتحالف بقيادة الولايات المتحدة (وهي الجهات الوحيدة التي لديها قوة جوية في البلد) جميعها أنكرت تورطها في هذه الغارات.
كتب الصحفي باتريك كوبورن في كتابه ‘عصر الجهاد’، “لقد كانت التغطية الإعلامية مليئة باليقينيات التي تلاشت أمام الواقع الفعلي. ففي سوريا، وأكثر من أي مكان آخر، ما من معلومات تتمتع بأي قيمة سوى إفادات شهود العيان”. وهذا الأمر هو أكثر ما يقلقني. فقد رأيت آلاف الصور ومقاطع الفيديو والتقارير. وتحدثت إلى عشرات الأشخاص الموجودين داخل سوريا. وأجريت اتصالات عبر سكايب مع ناشطين وسجناء وضحايا. وذهبت إلى مؤتمرات. والتقيت مع جماعات مناصرة وتتبّعت عمل منظمات الإغاثة الإنسانية. وكنت شاهدة ثانوية على الحرب وعملت على تغطيتها بصفة حثيثة، ورغم ذلك لم تطأ قدماي التراب السوري أبداً. وقد تسبب لي الاعتراف بهذا الواقع بقلق شديد من أن أوصف بالتدليس، ولكن هذا هو الواقع، كما هو واقع العديد من الصحفيين الدوليين الذين يغطون الحرب.
في السنوات المبكرة من الحرب، عندما كان الصحفيون الأجانب يتوجهون إلى سوريا بصفة متكررة، بعضهم من خلال تأشيرات حكومية في حين لجأ غيرهم لعبور الحدود بصفة غير شرعية، كنت ما أزال أدرس في الجامعة. وعندما جاء دوري أخيراً في عام 2014 كي أغطي الحرب، بات الصحفيون مستهدفين. وتقدّر لجنة حماية الصحفيين أن أكثر من 100 صحفي لقوا حتفهم منذ بداية النزاع. وكنتيجة مباشرة لذلك، أصبحت التغطية الصحفية مقيدة، وغالباً ما تقتصر على روايات غير مباشرة للإحداث.
وحالياً، ما زال يوجد عشرات الصحفيين السوريين في داخل البلد يخاطرون بحياتهم لتغطية الأخبار. (حققت لجنة حماية الصحفيين في مقتل 90 صحفياً على الأقل في عام 2015، ولكنها لم تتمكن من تأكيد سوى مقتل 14 صحفياً في ذلك العام). ومع ذلك، فإن قدرة معظم الصحفيين السوريين على التحرك تقتصر على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة أو تلك الخاضعة لسيطرة الحكومة، وليس بوسعهم عبور خطوط القتال للقيام بعملهم. ويتمكن بعضهم من نشر تغطيتهم في وسائل إعلام محلية ودولية، إلا أن معظمهم ينشرون المعلومات من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يلتقطها الصحفيون الأجانب.
يؤدي معظم الصحفيين الأجانب الذين يغطون الأحداث في سوريا عملهم من خارج البلد. إذ ينطوي دخول البلد بصفة غير مشروعة على خطورة شديدة. وحتى أولئك الذين يخاطرون بالدخول يجدون صعوبة في العثور على وسائل إعلام تقبل بنشر عملهم؛ فالعديد من وسائل الإعلام تحظر قبول تقارير الصحفيين المستقلين بسبب المخاطر الشديدة التي يواجهونها. أما الحصول على تأشيرة سفر للدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وتغطية الأخبار منها، فليست أمراً مستحيلاً، ولكن بعد تعرضي للقرصنة الإلكترونية من قبل الجيش السوري الإلكتروني بسبب تغطيتي وكتاباتي المكثفة حول تنظيم الدولة الإسلامية، فلا بد أن فرصتي في الحصول على تأشيرة سفر ضعيفة جداً.
ما زال بعض الصحفيين الأجانب يتوجهون إلى سوريا، رغم كل المخاطر، وقد حاولت أن أذهب بنفسي في نهاية عام 2015 عندما بدأ ناشطون سوريون حملة إعلامية لجلب الانتباه إلى وضع آلاف الناس الذين يعيشون تحت الحصار في مضايا، بالقرب من دمشق. فقد علِق المدنيون في مضايا منذ يوليو/ تموز 2015 ويتعرضون للتجويع فيها، ولكن نتيجة للحملة الإعلامية، باتت المدينة في نهاية العام تحظى بتغطية إعلامية مكثفة. وبدأت الصور والتقارير التي يبثها الصحفيون والناشطون السوريون حول الأطفال الجياع والهزالى تملأ صفحات فيسبوك وتويتر.
ويبدو أن الحصار الذي يعاني منه سكان مضايا تفرضه قوات حزب الله، وهو جماعة لبنانية مسلحة تقاتل إلى جانب النظام السوري. ومع ذلك، عندما بدأتُ في سعيي للتوجه إلى مضايا، كان مسؤولو حزب الله يسردون قصة مختلفة تماماً عما كانت تورده وسائل الإعلام: فقد زعم الحزب أنه لا يوجد حصار؛ وأن الناس ليسوا جياعاً؛ وأن الغذاء متوفر. وكان مسؤولو حزب الله يؤكدون على روايتهم إلى درجة أن بعض مقاتلي الحزب عرضوا اصطحابي إلى أطراف البلدة كي أرى بنفسي الإمدادات المتوفرة بكثرة.
لا يمكنني الدخول في تفاصيل القصة والخوض في الأسباب التي حالت دون قيامي بتلك الرحلة (فللمفارقة، يجب علي أن أمارس الرقابة الذاتية)، ولكن بعد عدة اتصالات هاتفية وزيارة قام بها موظف من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى منزلي في بيروت، قررت أن مستوى الخطر مرتفع جداً. وبعد بضعة أشهر من ذلك، ظل مسؤولو حزب الله ومؤيدو النظام السوري في بيروت يرددون المزاعم نفسها، فيما استمر تداول صور المدنيين المصابين بالهزال ، كما لقي ما لا يقل عن 86 شخصاً حتفهم من جراء الجوع.
تُمثل مضايا نموذجاً مصغراً للنزاع السوري، وتثير أسئلة ظلت تجول في ذهني منذ بدأت بتغطية الحرب: كيف يمكن لجماعتين أن تؤكدا بقوة على سردين مختلفين تماماً بشأن الوضع نفسه؟ ومن هي الجماعة التي تقول الصدق؟
يتمثل أحد أركان حملة العلاقات العامة التي شنها النظام السوري منذ بداية النزاع في وصف صور العنف والآثار الوحشية للحرب على أنها دعاية مضللة تبثها المعارضة أو “الإرهابيون”. وحتى أثناء كتابتي لهذه السطور، كان الأسد قد صرح لوكالة ‘أسوشيد برس’ بأنه “لو كان هناك حصار فعلاً حول مدينة حلب، لكان الناس قد ماتوا بحلول هذا الوقت”. بيد أن عمال الإغاثة الإنسانية والناشطين الموجودين في الميدان يرسلون أدلة عن الحصار بصفة يومية تقريباً. ولكن الأسد لديه إجابة عن هذا الأمر أيضاً: “إذا كنت تريد التحدث عن البعض الذين يزعمون بذلك، فإننا نقول لهم كيف تمكنتم من البقاء على قيد الحياة؟ … فالواقع يكشف الأمور”.
مع ذلك، يظل وصف الواقع في سوريا متحيزاً دائماً تقريباً. ففي بداية الحرب، اضطر معظم الناس في داخل سوريا إلى تأييد طرف دون الآخر. وسرعان ما وجدت الحكومات الأجنبية نفسها أمام الخيار نفسه، فباتت تعرب عن تأييدها لهذا الطرف أو ذاك. وما تزال معظم وسائل الإعلام الأجنبية تحاول مقاومة المطالب بأن تعلن عن تأييدها لأحد أطراف النزاع في سوريا. ولكن مع كل قصة نغطيها، فإننا نخاطر بأن نوسَم بأننا مؤيدون للمعارضة أو مؤيدون للحكومة: فإذا قلنا بأن الأسد يجوِّع شعبه، نكون بذلك مؤيدين للمعارضة؛ وإذا قلنا أن الأسد ينكر هذا الزعم، فإننا نُتهم بمناصرة النظام الإجرامي. وفي الوقت نفسه، من الصعب جداً علينا أن نورد حقائق ثابتة من الميدان ولا يمكن إنكارها.
واستجابة لهذا الوضع، فقد بدأنا نتكيف مع حالة الانعزال التي نجد أنفسنا فيها، ونسعى للعثور على طرق لتغطية الأخبار من سوريا بدقة حتى لو لم نكن موجودين فيها. فخلال الحصار على حلب (وكان مستمراً عند كتابة هذه السطور) استمر عشرات الصحفيين والنشطاء السوريين بإيصال تحديثات آنية للأخبار عبر مجموعة كبيرة مشتركة في تطبيق ‘واتسآب’، وكانوا يجيبون على استفسارات الصحفيين الأجانب ويرسلون الصور ومقاطع فيديو مصورة. ولكن في معظم الحالات ظلت التغطية مخففة نوعاً ما، فقد عمدت إلى توخي الحياد تحسباً من أن الأحداث الموصوفة لم تقع فعلاً. ولكن من الصعب أن تسمي الأشياء بأسمائها عندما لا تتمكن من رؤيتها بنفسك.
ثمة أيام يغمرنا فيها الإحباط ونود لو نستسلم، ونتحسر قائلين “الجميع يكذبون علينا بشأن سوريا!” ومع ذلك فليس بوسعنا الاستسلام. فقد يكون الجميع كاذبين، إلا أن الحرب حقيقية. وقد لا نحصل على تأشيرات سفر إلى سوريا، وحتى لو حصلنا عليها فإن تقييم المخاطر لرحلتنا إلى سوريا قد يدفع نحو الإحجام عنها. وقد تظل مساعينا بالكشف عن الحقيقة تُواجَه بتهديدات واتهامات بالتحيز. وطالما ظل في سوريا أناس يريدون إبلاغ العالم بقصصهم، سنظل نحاول أن نجد طريقة لإيصال أصواتهم. ولكن بالنسبة لمعظمنا نحن الصحفيين، فإن منعنا من مشاهدة الأحداث بأنفسها أو عدم قدرتنا على مشاهدتها تعني أن الحذر والحيطة اللذين نتوخاهما، ورغبتنا بالمحافظة على الحياد، تصبح بحد ذاتها نوعاً من الرقابة.
أليساندرا ماسي هي مديرة تحرير موقع ‘سيريا ديبلي’ ومديرة مكتب بيروت لموقع ‘نيوز ديبلي’.